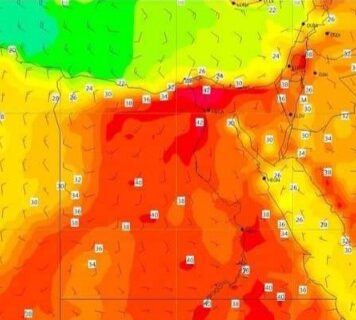بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70- 71].
أما بعد:
فقد اشتدت الحاجة في وقتنا الحاضر إلى تيسير العلم وتعريف الناس بأمور دينهم وتقريبه لهم، ليعبدوا الله ملخصين له الدين وفق ما شرعه الله في كتابه وجاء على لسان المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ولاسيما عامة الناس والجاليات حديثة العهد بالإسلام، وعرض الإسلام سهلًا مبسطًا، لعل الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، فنحظى جميعًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعلي رضي الله عنه: ) لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم (، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: ) خير الناس أنفعهم للناس (.
إن العلم النافع والعمل الصالح هما مفتاح السعادة وأساس النجاة للعبد في معاشه ومعاده، ومن رزقه الله علمًا نافعًا ووفقه لعمل صالح فقد حاز الخير، وحظي بسعادة الدارين، وإذا أكمل المسلم ذلك بنشر العلم وبذله للناس فقد كملت منه معاني الخير وأمارات الصلاح، وأصبح كالغيث أينما حل نفع، وهكذا عاش العلماء العاملون في كل عصر ومصر.
ولقد فكر بعض طلبة العلم – جزاهم الله خيرًا – في وضع هذا الكتاب الذي بين يديك – أخي القارئ – والذي يحتوي على ما لابد للمسلم منه بأسلوب سهل مبسط وباختصار شديد في العقيدة والعبادات والآداب والأخلاق وغيرها، يستطيع القارئ له أن يكون لديه فكرة واضحة عن دين الإسلام، ويجد فيه الداخل في دين الإسلام، مرجعًا أوليًّا في أحكامه وآدابه وأوامره ونواهيه، ويصبح هذا الكتاب في متناول الدعاة إلى الله يترجمونه إلى كافة اللغات، ويدفعونه إلى كل سائل عن دين الإسلام، وكل داخل فيه، فيهتدي بذلك من يشاء الله هدايته، وتقوم الحجة على أهل الزيغ والضلال، ولعله يكون مفتاحًا للخير، وهداية للناس إلى الرشد والصلاح، فيحظى المشاركون فيه بالأجر والثواب.
وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أشكر كل من بذل أو ساعد أو ساهم في إخراج هذه الفكرة من أصحاب الفضيلة، والمشايخ، وطلبة العلم الذين لم يبخلوا بنصيحة أو رأي سديد حتى خرج هذا الكتاب بحمد الله إلى حيز الوجود. وفق الله الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، ونسأله سبحانه أن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) لا يخفى أن الله بعث نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إلى البشر رحمة منه وإحسانًا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
(2) كانت العرب قبل بعثته -صلى الله عليه وسلم- في جاهلية جهلاء وشقاء، يعبدون الأصنام، ويئدون البنات، ويسفكون الدماء بأدنى سبب وبلا سبب، في ضيق من العيش، وفي نكد وجهد من الحياة، يتحاكمون إلى الكهان والطواغيت.
(3) فبعث الله هذا النبي الكريم، الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، من ظلمة الجهل والطيش، إلى نور العلم والحلم، ومن ظلمة الجور والبغي إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام، ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور، ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء، بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور الحياة السعيدة: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 122].
أكمل الله به الدين، وتمم به مكارم الأخلاق، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمعوزين، حتى قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»، وأمر بالتحاكم فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
وكلما ازداد المرء معرفة بالإسلام ازداد له احترامًا وتعظيمًا وتوقيرًا، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لكمال معرفتهم به أشد الناس تمسكًا به، وتمشيًا مع تعاليمه بكل جليل ودقيق، وإنه لمن العجب إعراض أكثر الناس في هذه الأزمنة عن تعاليم هذه الشريعة السامية الكاملة واستبدالها أو شوبها بقوانين وضعية ظاهرة التناقض واضحة الجور فاسدة المعنى، فلذا كثيرًا ما يطرأ عليها التغيير والتبديل، كل يرى أنه أحسن مما تقدمه وأدرى بالمصالح والمفاسد ممن سبقه، ثم يجري عليها تتغيرًا أو تبديلًا بحسب رأيه، وهكذا دواليك ما بقيت هذه النظم المستمدة من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان.. أما الشريعة الإسلامية فهي صالحة لكل زمان ومكان، مضى عليها أربعة عشر قرنًا، وهي هي في كمالها ومناسبتها وحفظها لكافة أنواع الحقوق لجميع الطبقات، وأهدأ الناس حالًا وأنعمهم بالًا وأقرهم عيشًا أشدهم تمسكًا بها، سواء في ذلك الأفراد أو الشعوب أو الحكومات، وهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان عاقلًا منصفًا وإن لم يكن من أهلها، بل وإن كان من المناوئين لها.
وقد سمعنا وقرأنا كثيرًا مما يدل على ذلك، فقد ذكر بعض عقلاء المستشرقين الذين يكتبون لبيان الحقيقة والواقع لا للسياسة: إن نشأة أوروبا الحديثة إنما كانت رشاشًا من نور الإسلام، فاض عليها من الأندلس، ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين في الشرق والغرب.
وقال القس تيلر: إن الإسلام يمتد في إفريقيا، وتسير الفضائل معه حيث سار، فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره، والشجاعة والإقدام من نتائجه. وقال كونتنس: يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجايا وشرف في الأخلاق، قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن بخلاف غيرهم، فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك. وقال أيضًا: إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسلم عزة في النفس، فهو سواء في حالة بؤسه ونعيمه لا يرى العزة إلا لله ولرسوله وله.
وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم إذا توفرت معها الوسائل كانت أعظم دافع إلى التسابق إلى غايات المدنية الصحيحة ورقيات الكمال.
وقال هانوتو، وزير خارجية فرنسا في وقته: إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان، وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرًا وأفواجًا، وهو الدين الإسلامي العظيم الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق أي دين سواه، فلا يوجد مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده فانتشر في الآفاق.
وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم، وجهلوا حكمه وأحكامه، وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال، فشا فيهم فساد الأخلاق، فكثر الكذب والنفاق والتحاقد والتباغض، فتفرقت كلمتهم، وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة، ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به.
وأقوالهم في هذا الموضوع كثيرة جدًّا يعترفون فيها بعظمة الإسلام وشموله، لعموم المصالح ودرء المفاسد، وأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم حقًّا لصاروا أرقى الأمم وأسعد الناس، ولكن ضيعوا فضاعوا، واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون.
منـاقــب شـــهـد العــدو بفضلها
والفضـل مـا شــــهـدت بـه الأعداء
ولسنا – والحمد لله – في حاجة إلى شهادة هؤلاء وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته، ولكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به، وعرف منه أعداؤه ما لم يعرفه بنوه، إذ جهلوا مصالحه، وتطلعوا إلى غيره من النظم الفاسدة المتناقضة، وأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال وأنه فوق كل نظام، ولا شك أنه الدين الصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البشر على وجه يكفل لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد، دين الفطرة السليمة، دين الرقي الحقيقي، دين العدالة بأسمى معانيها، دين المدنية والحرية بمعناها الصحيح، دين العمل، دين الاجتماع، دين التوادد والتناصح والتحابب، دين رفع ألوية العلم والصنائع والحرف، لم يقتصر على أحكام العبادات والمعاملات، بل شمل جميع منافع العباد ومصالحهم على ممر السنين وتعاقب الدهور إلى أن تقوم الساعة.
ولكن يا للأسف ويا للمصيبة، أن أبناء هذا الدين جهلوا قدره وجهلوا حقيقته، بل كثير منهم عادوه، وأصبحوا يدسون عليه معاولهم ليهدموه وليفرقوا أهله، ويفضلون أهل الغرب على المسلمين، ظنًّا منهم بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة: أن الدين هو الذي أخرهم، وهيهات أن يكون الدين هو الذي أخرهم، ولكنهم أخروا أنفسهم بالإعراض عن تعاليم دينهم، وأخلدوا إلى الكسل وقنعوا بالجهل، فأصبحوا في حيرة من أمرهم.
وإنه لمن أعظم الضلال أن يعتقد من يدعي الإسلام أن الشريعة لم تأت بما يكفل مصلحة الجميع، وأن الناس محتاجون إلى غيرها في شيء من شئونهم ومشاكل حياتهم، أليس ذلك طعنًا وتكذيبًا لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]. يا له من دين، ما أجله وما أكمله! فإن من تأمل حكم هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها، ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم مثلها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أنها أدركت حسنها، وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والنور والبرهان. وهي من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها، وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها، فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164].
وقال معرفًا لعباده، ومذكرًا لهم عظيم نعمته عليهم، مستدعيًا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]. قال بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالًا.